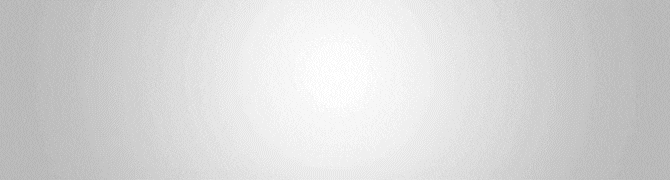جولة في رحاب الأندلس… تأملات في ماضٍ متخيل وحاضر ماثل

أخبار إسبانيا بالعربي – داعبتني الرغبة في زيارة المدن الأندلسية مع بدايات مرحلة تفتح الوعي والنزوع المعرفي لدي، وهو نزوع لم يكن مدفوعًا بالمتعة بقدر ما كان بحثًا عن أجوبة على الأسئلة الكبرى التي لاتزال تشغلنا وتؤرقنا كفلسطينيين وكعرب، والتي شغلت الفوج الأول من النهضويين العرب في القرن التاسع عشر، أي أسئلة التخلف والنهضة. ولكن ما لبثت هذه الرغبة أن فترت، وحل مكانها الانغماس في الواقع المعيشي وما يتطلبه من فعل وحراك يومي، الذي لا يترك مجالا للأحلام الخاصة، أو ترف العيش في الماضي، أو هكذا بدا لي.
واكتفيت ببعض ما قرأته عن بعض الأعلام الذين زاروا المدن الأندلسية، ومنهم من أبدعوا في الكتابة والبحث والنقد. ولكن مؤخرًا عاد إلي الفضول لمشاهدة عظمة الآثار العربية الإسلامية، التي لاتزال شاهدة على تجربة فريدة في تاريخ العرب والمسلمين. وبالرغم من أن تلك التجربة، تجربة عربية إسلامية أنتمي إليها، إلا أنها – في الوقت ذاته – جزءٌ من التجربة الإنسانية الحضارية، إذ لا توجد حضارة منفصلة عن التجربة البشرية الشاملة.
ما أعاد بعث تشوّقي للزيارة هو عودة الحضور لهذه التجربة الحضارية بصورة مكثفة، في دراسات وبحوث ومقالات وروايات أدبية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، والأهم، ظهور ما يسمى بالمؤرخين الإسبان الجدد، الذين نسفوا أساطير منتشرة عن مقدمات وطبيعة الدخول أو الفتح العربي للأندلس في القرن الثامن الميلادي، من خلال قراءة وتقويم تاريخ وحضارة الأندلس، ودور العرب فيها، ودعوتهم لاستلهام تجربة التعايش الأندلسية في مقاربة مشكلة الكراهية والتعصب المنتشرة في عصرنا الحالي، والعداء ضد المسلمين واللاسامية ضد اليهود.
وتقول قراءتهم إن دخول العرب إلى الجزيرة الإيبيرية، كان مشروع تنوير ونهضة حضارية وليس غزوًا بالمفهوم التقليدي، والذي، بحسبهم، كان استمرارًا لموجات من الهجرة أو انتقال قبائل عربية وبربرية، من المغرب وشمال أفريقيا، حيث كان الإسلام قد وصلها، حتى جاء الدخول العربي البربري الإسلامي المنظم، وبالطريقة العسكرية، بقيادة القائد البربري طارق بن زياد، وبأمرٍ من موسى بن نصير، ممثل الخلافة الأموية، في شمال أفريقيا، واستجابة لنداء أرسله الكونت يوليان، الحاكم البيزنطي لمنطقة سبتة، وهي إحدى الجيوب الأوروبية في البر الأفريقي، التي تطالب المغرب باستعادتها من إسبانيا.
كما يسهم في هذا الاهتمام المتجدد، الجهد الأكاديمي الجاري لإزالة الستار عن عملية طرد اليهود والمسلمين، حوالي نصف مليون، بصورة وحشية، وحرق مئات آلاف المخطوطات العربية، بعد سقوط مدينة غرناطة، آخر معاقل الدولة العربية في الأندلس، أي بعد انتصار الممالك الكاثولوكية الإسبانية على الوجود العربي. وهي سابقة في عمليات التطهير العرقي التي شهدها العالم لاحقًا، كما يقول، المؤرخ والباحث البريطاني، ماتثيو كار، صاحب كتاب “الدين والدم، إبادة شعب الاندلس”. ويستعرض كتابه وبحوث أخرى، عمليات التنصير التي فرضها الحكم الجديد على هؤلاء، وإجراءات محاكم التفتيش الوحشية، والعذابات الرهيبة التي تعرض لها مئات الآلاف، قبل أن يصدر قرار نهائي عام 1609، بالطرد الكلي.
اعتبرتُ في مرحلة معينة من حياتي، أي قبل تبلور منظومة أفكاري السياسية ومنظوري الكوني، أن لا طائل من زيارة أطلال نبكي عليها، ولا مواصلة اجترار محنة عربية إسلامية انتهت قبل خمسمائة عام، في بلد يقع في أقصى غرب القارة الأوروبية، بل المطلوب تركيز اهتمامنا في فلسطين وقضايا مجتمعنا الحارقة، وحالتنا العربية الراهنة، وأنه تكفي المعاناة اليومية التي نشهدها في فلسطين بنكبتها الفظيعة المستمرة..
إلى أن تغير قراري، فقررت أنا وزوجتي زيارة الأندلس، بعد أن حانت الفرصة، وبعد أن تسنى لي الاطلاع على بعض مستجدات البحث والكتابة، من قبل كتاب وباحثين وأدباء مرموقين، في هذا الشأن، وبعد ظهور دراسات جديدة ومبادرات إنسانية تسعى لاستلهام تجربة التعايش الأندلسية، لاعتمادها أنموذجًا للتعايش في مناطق مضطربة في العالم، ومنها الواقع في فلسطين. (مثلا، ثمة بدايات لتشكيل ملتقى أممي هدفه العمل والترويج لفكرة التعايش، من خلال تحقيق العدالة في فلسطين استلهاما للأنموذج الأندلسي).
أنا لستُ باحثًا، ولا أديبًا أو شاعرًا، ولم آتِ إلى الأندلس لكتابة الشعر أو الأدب أو البحث عن الماضي الأندلسي، فقد قام بهذا الواجب أو المهمة، وعلى أتم وجه، أفضل أصحاب هذه المواهب والاختصاصات من العرب والمسلمين، ومؤخرا من الإسبان. لقد جئتُ إلى إسبانيا متجردًا من المشاعر الرومانسية، التي كانت تتحكم بي في أيام الشباب مثل الكثيرين، فقد كان الغرض قضاء فترة نقاهة، وفي الوقت ذاته رغبة في التزود بمزيد من المعرفة عن الإسهام العربي الإسلامي في الحضارة الإنسانية، وما يمكن الاستفادة منها معرفيا وعمليا، بصفتي ناشطا سياسيا، وكأحد المهتمين بالتاريخ بصفته تجربة بشرية مترابطة، وكوني من المعنيين بالتغيير، والمهجوسين بالمستقبل، وربما يستفيد منه الكثيرون من عامة القراء المحبين للمعرفة والراغبين في التسلح بأفكار مفيدة في عملية التأثير الثقافي والمجتمعي.
ولكن بعد أن انقضت عشرة أيام من الزيارة والتنقل اليومي بين الآثار العظيمة، كالصروح العلمية، والقصور المدهشة والجوامع والبيوت الجميلة، وكذلك الكنائس الضخمة، والجنائن الساحرة، وما تعكسه من قدرة هندسية ومعمارية فائقة، في خمس مدن هي: قرطبة، وغرناطة، وإشبيلية، وطليطلة، وجزئيا مدريد، وبعد أن مشينا في غالبية أزقتها الضيقة، لساعات طويلة يوميا، والاستماع للمحاضرات، والإقبال على المزيد من القراءة خلال أيام الزيارة، خلال السفر في القطارات، أو في آواخر الليل، بعد كل ذلك وجدت أن شعورًا عميقًا لم أتوقعه، تملكني وغمرني بأنني في الأندلس القديمة، العريقة، وليس في إسبانيا المعاصرة.
لقد أعادت هذه الزيارة/ الجولة إطلاق التأملات والتفاعل مع التجربة ذاتها ولكن بارتباطها بالتجربة الإنسانية بوجهيها البهيّ والمثير، والبائس والمأساوي، وأعادتني إلى الواقع العربي الإسلامي المأساوي الراهن، – وبقوة أكبر – إلى أسئلته الموجعة والتي حاولت الثورات العربية استئناف العمل للإجابة عنها بصورة عملية، قبل أن يحطم أحلامها الحكام الذين ينسخون بؤس الحكام السابقين الذين أفسدوا وأضاعوا المنجز العربي الإسلامي. كما أنها تدفعك مرة أخرى للتأمل في مسيرة المجتمع البشري التاريخية المخضبة بالحروب والدماء والتقلبات، ونزوات ووحشية الحكام وعدم عقلانية بعض المتاجرين بالدين، من ناحية، وعظمة الإنجازات الإنسانية في المجالات كافة، وعقلانية رجال سياسة ورجال دين من ناحية ثانية، وكيف أن كل ذلك يطبع مسيرة الشعوب والدول ويؤثر في مآلاتها بصورة حاسمة.
لم أتوقع أن يغمرني هذا الشعور بهذه الحدة، بالرغم من أنّني قرأت عن مشاعر أدباء وشعراء كبار ونهضويين، عن زيارتهم الأولى، مثل النهضوي اللبناني، شكيب أرسلان، والشاعر نزار قباني، والأديبة الراحلة رضوى عاشور (ثلاثية غرناطة)، وغيرهم من المثقفين المشرقيين والمغاربة والمصريين، الذين فاضت عواطفهم في أثناء حضورهم إلى هذا البلد، في فترات من القرن العشرين. وكما لاحظ الدارسون لهذه التجربة العربية الإسلامية الأندلسية، فقد كانت قد اختفت من الذاكرة العربية، لثلاثة قرون، ولم تعد للحضور إلا في بداية القرن العشرين، وهناك من يرى أن تجدد هذا الاهتمام العربي والإسلامي، جاء مترافقا مع عودة الاستعمار الغربي للعالم العربي ولفلسطين، حيث باتت محنة فلسطين تقارن بمحنة العرب في الأندلس.
التاريخ ليس ماضيا فحسب
ليس التاريخ ماضيًا فحسب، بل هو حاضر في الحاضر أيضا، ومُشكل للهويات، ومحرك لمشاريع كبيرة، سواء تحررية إنسانية، أو رجعية، عدوانية وعنصرية. ما يدفع المؤرخين الإسبان الجدد، في إعادة قراءة التجربة العربية في الأندلس ليس من مبدأ الموضوعية في البحث الأكاديمي فحسب، وليس من باب إنصاف الدور العربي والإسلامي في إرساء تجربة نهضوية فريدة في بلد أوروبي كان كبقية البلاد الأوروبية يعيش ظلام العصور الوسطى، تلك النهضة العربية الأندلسية التي شكلت مصدرا أساسيا للنهضة الأوروبية الكبرى التي انطلقت في القرن الخامس عشر، بل الرغبة في الإسهام في تغيير موقف الإسبان، وكذلك الأوربيين، من الإسلام، وفرملة العداء والتحريض والإقصاء الذي يشتد ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا، وفتح أفق للتعايش والحياة المشتركة عبر الاعتراف واحترام التعددية الثقافية.
فالمناهج الدراسية الإسبانية الرسمية تتجاهل إلى حد كبير، قرونا من الوجود العربي في التاريخ الإسباني، ويعرض اليمين المتطرف الوجود العربي الماضي وكأنه غزوٌ وحشي وفرض للدين الإسلامي على الجزيرة الإيبيرية، وسعي للقضاء على الكاثولوكية، وأن الممالك الإسبانية المسيحية التي – من خلال وحدتها – قامت بعملية الاسترداد، في نهاية القرن الخامس عشر. فالباحث المستعرب الأشهر، بدرو مارتينث مونتابث، المعروف بدفاعه عن قضية فلسطين، يقول: “لا يمكن تفسير إسبانيا من دون الأندلس… فالأندلس تاريخ مشترك يتقاسمه الإسبان والعرب”.
أما الأكاديمي، إيميليو غونزاليس فيرين، صاحب كتابي “قصة الأندلس” و “عندما كنا عربا”، يعود بنا إلى خلفية الدخول العربي والإسلامي إلى الجزيرة العربية، متعمقا في السياق الديمغرافي والعرقي والجيوسياسي الذي كان قائمًا في إيبيريا، ومنطقة شمال إفريقيا بل في منطقة البحر المتوسط، من حيث التمازج الثقافي والهجرات المتبادلة من جهة، ومن جهة ثانية أن إيبيريا كانت تعيش حالة من التفكك والنزاعات الداخلية، بسبب استبداد وفساد حكامها. ويقول: إن ما حدث في الجزيرة الإيبيرية لم يكن غزوًا ناتجا عن حرب مقدسة بل كانت سلسلة من موجات الهجرة التي ولدت عملية تعريب للمنطقة.
ويفسره وغيره من المؤرخين الجدد أن سهولة انتصار طارق بن زياد على الملك القوطي، رودريك، نابع من تعاون يوليان معه، والشروط السهلة التي قدمها للسكان الذين كانوا يعيشون في ظل استبداد هذا الحاكم القوطي، والطبقة التي كانت تسانده. وسبب آخر هو أن غالبية القوط، وهم قبائل جرمانية كانت غزت الجزيرة واستقرت فيها في حقبة سابقة، كانوا يتبعون المذهب المسيحي الآريوسي، أي التوحيدي، الرافض لفكرة التثليث، والذين كانوا يتعرضون للاضطهاد والقهر من قبل الممالك الكاثوليكية في الشمال، على خلفية الاختلاف في فهم العقيدة المسيحية، والمصالح السياسية المتضاربة.
وباختصار، فإن سببين رئيسين قادا إلى التسليم بحكم المسلمين البربر
والعرب، الأول هو تقارب العقيدة الآريوسية، التي لا تعد المسيح إلهًا بل رسولًا من عند الله، مع العقيدة الإسلامية التوحيدية. وثانيا، أن معاهدة التسليم التي تمت، بعد مقتل رودريك، قدمت شروطا مغرية مقارنة مع ما ذاقوه من الخصوم الآخرين، مثل عدم إجبارهم على الدخول في الإسلام، احترام كنائسهم ومعابدهم وممارسة شعائرهم الدينية، وعدم استعبادهم أو مصادرة أملاكهم، مقابل احترام الحكم الإسلامي ودفع الضريبة/ الجزية. وكذلك انطبق الأمر على اليهود.
تحولت الأندلس تحت حكم العرب والإسلام، إلى معقل ثقافي وحضاري فريد في فترة كان التخلف والجهل يسود أوروبا، بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، واندثار الإرث الحضاري الروماني والإغريقي، والذي قام المسلمون باستعادته وتجديده، والاستفادة منه، ورده إلى أصحابه. والمفكر والفيلسوف والقاضي ابن رشد، شارح فلسفة أرسطو، الذي ظلت أكاديميات أوروبا تدرسه لأكثر من مئتي عام بعد انهيار التجربة الأندلسية وبزوغ عصر النهضة الأوربي، مثال واحد فقط على عظمة الدور الذي قام به المثقفون العرب في التجربة الأندلسية والأوربية. كما مثلت تلك التجربة أنموذجا للتمازج الحضاري، والتعايش بين الأديان الثلاثة.
لم تكن فردوسا مثاليا ولكن…
لم تكن الأندلس، في زمن الحكم العربي والإسلامي، فردوسا مثاليا. فقد كانت حقبة تاريخية، ذات ثمانية قرون، زاخرة بالحضارة، والثقافة، والعلم، والتعايش، والآمال ولكنها أيضا شهدت فترات من الاقتتال الداخلي، والمؤامرات والفساد والتعصب الديني، سواء داخل الممالك الإسلامية أو الممالك النصرانية. لم تسقط الدولة العربية الإسلامية دفعة واحدة، بل على مراحل امتدت لقرون. ولم تسقط أيضا فقط بسبب توحد الممالك الكاثوليكية، في شمال إسبانيا، ضد الوجود العربي والإسلامي بعد زواج الملكة إيزابيلا والملك فرناندو، بل أساسا لأسباب داخلية، لها علاقة بالاستبداد وبكيفية إدارة الحكم وتدبير أمور الناس، وانحراف الولاة نحو اللهو والبذخ، والشهوة للسلطة وما ينطوي على ذلك من استسهال الاقتتال الداخلي، والتحالف مع الأعداء.
لقد سقطت أول مدينة مهمة، وهي توليدو، أي طليطلة، الواقعة في وسط إسبانيا، عام 1085، بينما سقط آخر معاقل الدولة العربية الأندلسية، غرناطة عام 1492، بمعاهدة تسليم، بعد اقتتال عربي داخلي، وبعد حصار طويل من قبل مملكتي قشتالة وأراغون. ويعود سبب ثبات ومواصلة الحضور العربي في الأندلس لمدة ثلاثة قرون أخرى أساسا لدور دولة المرابطين في المغرب، بقيادة يوسف بن تاشفين، الذي استجاب لنداء الأمراء العرب، بعد سقوط مدينة توليدو (طليطلة) وتصاعد عملية الإكراه ضد المسلمين في المدينة وأريافها.
وقد دهش الباحثون، خاصة ممن باتوا يُعرفون بالمؤرخين الجدد، باكتشاف عملية التطهير العرقي والمعرفي، ضد الوجود العربي الإسلامي واليهودي، بعد سقوط غرناطة، بعد تمكنهم من الدخول إلى أرشيف الدولة الإسبانية، وتساءلوا بصورة استنكارية كيف يمكن لدولة منتصرة، أصبحت أقوى دولة في أوروبا، أن ترتكب هذه الإبادة الجهنمية، بحق شعوب عاشوا هناك لقرون طويلة، شيدوا نهضة علمية وثقافية وفلسفية ومعمارية مدهشة، من خلال تمازج كل الأقوام والأديان والإثنيات المحلية والمهاجرة.
وينشرون وثائق ومراسلات، منها ما ورد بأن عمدة مدينة غرناطة الكاثوليكي، اعترض على قرار الملكة إيزابيلا والملك فرناندو، بطرد العرب واليهود وحرق كتبهم قائلا: إن المسلمين لم يدمروا كنائس ولا كنسا، ولم يحرقوا كتبا، ولم يجبروا أحدا على التحول إلى الإسلام، فلماذا نفعل ذلك؟ ويستمر السجال حول هذه الفعلة الهمجية، في التذكير بأن نظام الحكم الإسباني آنذاك، وبعد استكمال ما يعد في الخطاب الرسمي “حرب الاسترداد”، أي تحرير أو استرداد الأندلس من المسلمين.
كانت الدولة الأولى، ومن خلال كولومبوس، التي نفذت إبادة جديدة في الأميركيتين، للسكان الأصليين، طمعا بالثروات والذهب، وفتحت الباب أمام القوى الغربية الأخرى لتأتي وتمارس دورها الاستعماري الإبادي هناك، أي خمسمائة عام من النهب والقتل والاغتصاب. ليس هذا فحسب بل طال الاستعمار الإسباني – أيضا – القارة الإفريقية التي حولها الأوروبيون إلى مصدر لاستجلاب العبيد إلى القارة الأميركية لخدمة البيض. لقد جلب الملايين، ومات الملايين منهم في أثناء نقلهم في القوارب.
خلاصة
تكمن أهمية الاطلاع مجددًا على تلك التجربة العربية الإسلامية المبهرة في كونها أولا، حاضرة في ثقافة بلد أوروبي تربط شعبه علاقات جيدة مع العرب والقضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ عليها وتطويرها، بالرغم من تصاعد منظمات اليمين المعادية للعرب والفلسطينيين والإسلام. ويذكر أن إسبانيا ظلت رافضة لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل حتى عام 1986.
ويُفهم من كتابات المؤرخين الإسبان الجدد (بما فيها كتابات المؤرخ البريطاني ماثيو كار) أنّ هدفها هو تنبيه الحكومات والمسؤولين الحاليين من خطر تكرار كارثة حرب الإبادة العرقية والمعرفية التي نفذها الحكم الإسباني القديم، المتشدد، في أواخر القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر، بعد حملات متطرفة شارك فيها قساوسة وأصحاب مصالح، ضد المسلمين آنذاك، في إسبانيا وأوروبا اليوم. كما أنه في الوقت ذاته، ومن جانبنا، يجب التعبير بقوة عن اشمئزازنا، ورفضنا للدعوات التي أطلقتها وتطلقها من حين لآخر، منظمات إسلامية جهادية دموية ومتوحشة “لتحرير الأندلس من الصليبين”، لأن من أبدع التجربة العربية الإسلامية، وفي القلب منها التجربة الأندلسية، ليس لهم علاقة بعقلية هذه المنظمات المتوحشة، وما كان ممكنا أبدا تحقيق ذلك من خلال هذا التوحش.
ثانيا، الاستفادة من تجربة التعايش الأندلسية، الرسمية والشعبية، التي ظلت سائدة، في المستوى الشعبي حتى عندما كانت تمر الجزيرة الإيبيرية في تقلبات سياسية على مستوى الحكام. فالثقافة الإسبانية، لا تزال متأثرة باللغة والأدب والشعر الأندلسي. وفي ظروف انتشار التعصب والكراهية، والتحريض ضد جماعات إثنية وعرقية، في أوروبا وأميركا والهند، وخاصة فلسطين، حيث يقوم نظام أوروبي استعماري استئصالي، والذي أقام منظومة قهر عنصرية على أنقاض الشعب الأصلي، هادمًا للتعايش الذي كان قائما قبل الغزو، تصبح مسألة تحقيق العدالة والتحرر والتعايش الإنساني، وتصعيد النضال، من خلال إقامة الأطر والائتلافات الأممية، الإنسانية، والتحررية، واجبا وضرورة قصوى.
المصدر: الكاتب الفلسطيني عوض عبد الفتاح / إسبانيا بالعربي.