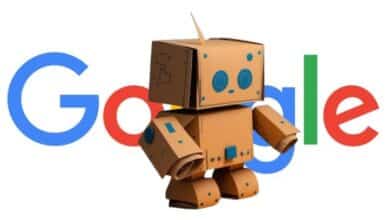ما سر غرام الإسبان بالإقامة في الشقق لا البيوت المنفصلة؟

على مدار الأسابيع التي شهدت فيها إسبانيا تطبيق نظام صارم للإغلاق الكامل، انتشرت في مختلف أنحاء العالم صور ولقطات لمواطني هذا البلد، وهم يصفقون في شرفات شققهم تحية للعاملين في مجال الرعاية الطبية.
وقد لاقت هذه الصور احتفاءً كبيرا باعتبارها تمثل مشهدا يُثلج الصدر ويعبر عن التقدير والامتنان للواقفين على الجبهة الأمامية لمواجهة وباء كورونا، كما بدت مؤشرا يعزز فكرة، مفادها أن الشقق السكنية تشكل جوهر المناطق الحضرية في إسبانيا.
وتشير بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” إلى أن إسبانيا بها أحد أعلى النسب بين دول أوروبا من حيث عدد من يقطنون شققا سكنية في أراضيها، إذ تصل نسبتهم إلى نحو ثلثيْ السكان، وهو ما يجعلها تحتل المركز الثاني بين دول الاتحاد على هذا الصعيد، بعد لاتفيا.
ففي إيطاليا مثلا، تصل هذه النسبة إلى نحو نصف السكان، بينما تزيد عن الثلث بقليل في فرنسا، ولا تشكل سوى 15 في المئة من القاطنين في المملكة المتحدة.
ويقول فرناندو أنثينار، من موقع “إدياليستا” للعقارات في إسبانيا، إن الشقق تمثل قرابة 65 في المئة من المنازل المطروحة للبيع في بلاده، مُقارنة بما لا تزيد نسبته عن 25 في المئة فقط من الوحدات السكنية المتاحة على موقع “رايت موف” المتخصص في المجال نفسه في المملكة المتحدة.
ومن بين الإسبان الذين يقطنون شققا مثل هذه، ميغيل كوبوس – المعلم البالغ من العمر 38 عاما – الذي لم يغير مكان سكنه في أحد أحياء العاصمة مدريد منذ سنوات طويلة. ويقيم الرجل حاليا في ما يسميه “شقة صغيرة للغاية”، وهي عبارة عن مسكن لا تزيد مساحته عن 25 مترا مربعا، في بناية عتيقة شُيّدت على طراز معماري كان سائدا في البلاد خلال القرن التاسع عشر.
ويقول كوبوس: “يعيش الإسبان في شقق بسبب عدم وجود منازل متاحة لهم بأسعار معقولة. المشكلة أنه حتى في حالة العثور على منزل بهذه المواصفات، فسيكون بعيدا للغاية عن وسط المدينة أو عن أماكن العمل”.
ولا يخفي المعلم الإسباني الشاب رغبته في أن يمتلك منزلا ذات يوم، في قرية جبلية على مشارف مدريد، يمتلك والداه منزلا فيها. فهذا الخيار لا يبدو متوافرا في العاصمة، إذ أن “الشقق تمثل من الناحية العملية كل ما هو معروض من الوحدات السكنية في مدريد”.
التوسع رأسيا
وتقول المؤرخة غلوريا رومان، الطالبة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة رادبود نايميخن الهولندية، إن مرحلة ازدهار عمليات تشييد الشقق السكنية في إسبانيا بدأت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في ظل حكم الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو، وذلك عندما نزح السكان من المناطق الريفية للبحث عن عمل في مدن البلاد المختلفة، وهو ما أطلق حركة نمو هائلة في المناطق الحضرية.
وتضيف رومان، وهي باحثة كذلك في معهد “إن آي أو دي” الهولندي بالقول: “في ذلك الوقت، أصبح من الضروري على وجه السرعة تشييد مساكن بشكل مكثف لخدمة أبناء الطبقة العاملة. وقد تقرر أن يتم هذا النمو بأسلوب رأسي لا أفقي، لأن تكاليفه كانت أقل”.
من جهة أخرى، تمنح قوانين تقسيم الأراضي التي لا تزال سارية في إسبانيا حتى اليوم وضعا متميزا للمناطق المحيطة بالبلدات والمدن، وهو ما يجعل بناء البيوت فيها مكلفا. ويقول الباحث الاقتصادي خافيير دياز خيمينز، من كلية “آي إي إس إي” لإدارة الأعمال في مدريد، إن: “عدم وضع قواعد كافية في هذا الصدد، بما في ذلك تطبيق قانون للبناء حافل بالقيود، أدى إلى تقليص الحوافز المتوافرة لبناء المنازل، وهو ما جعل التوسع الرأسي أكثر فعالية بشكل كبير، وأقل تكلفة أيضا”.
وهكذا نشأ الكثير من الإسبان في شقق في مبان مرتفعة، ما جعلهم يعتادون استخدام المصاعد. أما وجود درج داخل الشقة، فكان بالنسبة لهم ضربا من الخيال، وفقا لدياز خيمينز، الذي يقول: “كانت فكرة أن يعيش المرء في منزل ذي مستوييْن أمرا استثنائيا وغير معتاد ولا يعرفه أحد” تقريبا في إسبانيا.
ولا يزال هذا الرجل يتذكر حتى الآن شعوره بالدهشة عندما فوجئ بوجود درج داخل المنزل الذي كان يقيم فيه أثناء رحلة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن لتحسين لغته الإنجليزية حين كان عمره 12 عاما.
تملّك منزلك
ومع أن إسبانيا قد توصف بأنها أمة من قاطني الشقق، فإنها تشكل – تاريخيا – كذلك أمة من المهتمين بامتلاك الوحدات السكنية التي يعيشون فيها. ويشكل ذلك الأمر سببا آخر يفسر الشعبية الكبيرة التي حظيت بها الشقق في المجتمع الإسباني، نظرا لأنها كانت أقل تكلفة بوجه عام بالنسبة للراغبين في شراء منازلهم.
ووفقا لأرقام “يوروستات”، بلغت نسبة الإسبان الذين كانوا يمتلكون منازلهم في عام 2018 قرابة 76 في المئة، مُقارنة بـ 65 في المئة من الفرنسيين والبريطانيين، و52 في المئة من الألمان.
ولفهم هذا الوضع، يتعين علينا العودة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أدت الظروف التي كانت سائدة آنذاك وقوانين الإيجار الجديدة التي طُبِقَت في تلك الحقبة، إلى أن يرى غالبية الإسبان – وللمرة الأولى – أن الهدف الرئيسي لهم في الحياة، يتمثل في أن تكون لديهم ملكية عقارية خاصة، وهو أمر حظي بتشجيع فرانكو، الذي اعتبر نظامه أن المنزل هو القلب النابض للمجتمع الكاثوليكي.
وتقول رومان إن الشقق شكلت حلا مثاليا لسد هذا “الاحتياج المزدوج، لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية في وقت قصير وبسعر زهيد من جهة، ولتلبية رغبة الإسبان في امتلاك مساكنهم الخاصة من جهة أخرى. ففي ذلك الوقت؛ مثلّ امتلاك العقارات في إسبانيا، أحد الرموز الرئيسية للازدهار والرخاء”.
وكانت الشقق المُشيّدة حديثا، تشهد فعاليات باذخة لتدشينها، تشمل مراسم لتسليمها إلى سكانها الجدد، ومباركة لها من جانب أحد القساوسة، وهي أمور روجت لها – كما تقول رومان – آلة الدعاية التابعة للنظام الديكتاتوري، الذي كانت تخضع له إسبانيا في تلك الآونة، نظرا لكونها كانت تتلاءم مع سياسات هذا النظام. ويُعزى ذلك جزئيا، إلى أن الرسائل التي دأبت الحكومة على توجيهها وقتذاك لمواطنيها، كانت تفيد بأن امتلاك وحدة سكنية “يمثل أحد المطامح الأساسية للحياة” بالنسبة للكثير من الأسر الفقيرة.
فضلا عن ذلك، لم يكن مستغربا إقامة مراسم للاحتفاء بشراء هذه الشقة أو تلك، في بلد يعاني اقتصاده من التضخم. إذ كان ذلك الوضع يدفع غالبية السكان لاستثمار أموالهم في السوق العقاري. ويقول الباحث الاقتصادي دياز خيمينز في هذا الشأن: “لم تكن أسواق الأسهم متطورة للغاية في ذلك الوقت، وكان معدل التضخم مرتفعا على نحو يؤدي إلى تآكل مدخرات المرء، وكان الاستثمار في العقارات يشكل السبيل الأمثل، للحفاظ على قيمة هذه المدخرات”.
الشعور القوي بالانتماء للمجتمع
ورغم أن السبب الرئيسي لتفضيل الإسبان الإقامة في شقق سكنية ربما يكون اقتصاديا؛ فإن ثمة من يرى أن هناك مؤشرات تفيد بأن مواطني هذا البلد يؤْثِرون أن يقطنوا في مساكن متجاورة، وهو ما توفره لهم الشقق. وقد تبين بالفعل أن الإحساس بالانتماء للمجتمع، تعزز لدى الكثيرين في إسبانيا، بفعل نشأتهم محاطين بجيرانهم.
ويعلق الخبير في علم الاجتماع الحضري بجامعة برشلونة مارك برادي (40 عاما) على ذلك قائلا إن هيمنة الشقق على سوق الإسكان في بلاده أفرزت “أحياء قوية ونابضة بالحياة في غالبية المدن، ما عزز الحياة الاجتماعية هناك”. وفي الواقع، تمثل هذه الأحياء، وما يكتسي به السكن في قلب البلدة أو المدينة من جاذبية، عامليْن يجتذبان الكثيرين للإقامة في مثل هذه الشقق.
وتعتبر الصحفية كليا هاوس (37 عاما) أن الحياة المتماسكة اجتماعيا بهذا القدر تمثل “أحد الأشياء الرائعة التي يتسم بها المجتمع الإسباني”. وقد حدا ذلك بهاوس للعودة من لندن إلى مدريد، حيث مسقط رأسها، لكي تربي أطفالها هناك. وتقول الصحفية الشابة في هذا الصدد: “أردت أن يتربى أطفالي على هذا الشعور القوي بالانتماء للمجتمع والتقارب الشديد بين أفراد الأسرة. كانت نشأتي على هذه الشاكلة أمرا مميزا بالنسبة لي، ورَغِبت في أن يشعر أبنائي بذلك أيضا”.
ومن بين الأسباب التي تجعل بوسع الإسبان التكيف بشكل مثالي مع مسألة الإقامة في شقق سكنية؛ حقيقة كونهم يقضون جانبا كبيرا من الوقت خارجها، للالتقاء في الحانات والمتنزهات والساحات العامة بالمدن والبلدات، مُغتنمين في ذلك فرصة الطقس الجيد الذي يسود بلادهم في الكثير من الأوقات.
وفي عام 2018، أظهرت دراسة أعدها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن الوقت الذي قضاه الإسبان في تناول الطعام خارج منازلهم، يفوق كثيرا نظيره الذي خصصه لذلك مواطنو العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما أشارت الدراسة إلى أن 15 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي للأسر الإسبانية، خُصِصَ في ذلك العام لتغطية نفقات التردد على المطاعم والحانات، مُقارنة بالمعدل المتوسط السائد في هذا الشأن في الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزيد على 9 في المئة.
وفي عام 2018 أيضا، كشفت دراسة أخرى عن أن الإسبان يقضون خارج منازلهم يوميا، وقتا يفوق بشكل كبير ذاك الذي يقضيه البريطانيون على سبيل المثال.
وترى كريستينا آتشا (45 عاما)، وهي أحد مؤسسي مكتب “آيه زد آيه بي” للهندسة المعمارية في مدينة بلباو الإسبانية، أن هناك صلة وثيقة بين شكل الاختلاط الاجتماعي في بلادها، ووجود أماكن وفضاءات عامة. وتقول في هذا الصدد إن ذلك “يحدو بنا – بوجه عام – لإبعاد منازلنا عن الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية بشكل أكبر، وجعلها مكانا مخصصا للأعمال منزلية الطابع”.
“مزايا محدودة”
لكن السُكنى في شقق قد لا يخلو من سلبيات أيضا. فالشقق ذات المواصفات الأقل تميزا من غيرها، تحتوي عادة على مطابخ صغيرة المساحة، وتتألف من عدد أقل من الغرف، كما تصل إليها الضوضاء والروائح مما يجاورها من شقق.
وتقول آتشا إن التحدي الرئيسي هنا، يتمثل في تصميم الشقق على نحو يجعلها تجمع بين وجود مساحات داخلية حميمية الطابع من جهة، وأن تبعث في قاطنيها أقصى قدر ممكن من التفاؤل بفعل الحرص على أن ينعموا وهم فيها بالضوء والهواء النقي والإطلالة الرائعة، من جهة أخرى. وتعتقد هذه السيدة أن تصميمات المنازل في المستقبل، ستعكس التغيرات التكنولوجية وإدراك البشر بشكل متزايد، أن قدرتهم على الاستمتاع بجمال الطبيعة، وهم في بيوتهم، بات بمثابة حق لهم.
ومن بين التغيرات الأخرى التي ستؤخذ في الحسبان في هذه الحالة؛ تزايد عدد الشبان الذين يعملون لحسابهم الخاص من منازلهم. وتشير آتشا إلى أن ذلك “قد يعني ظهور حاجة لأن تُدمج في تصميم الشقة، مساحات جديدة تُخصص لهذا النوع من العمل أو ذاك”. وتضيف أن إجراءات الإغلاق المرتبطة بتفشي وباء كورونا والتي استمرت لفترة طويلة، أجبرت البشر على أن ينظروا إلى منازلهم من منظور جديد، وكأنهم “يعيدون دراسة وفحص علاقة قديمة”.
يتبنى هذا الرأي كذلك عالم الاجتماع مارك برادي، الذي يشير إلى أن تدابير الإغلاق – بما شملته من منعنا من استخدام الأماكن والفضاءات العامة – كشفت النقاب عن “المزايا المحدودة” للإقامة في كثير من الشقق السكنية.
ويقر برادي بأنه من العسير التكهن بحدوث تغيرات، خلال فترة ما بعد انتهاء إجراءات الإغلاق، على صعيد النظرة للإقامة في وحدات سكنية مثل هذه.
لكنه يرى أيضا أن المشكلات المتعلقة بمدى جودة الحياة في تلك الشقق – والتي أُلقي الضوء عليها في فترة الحجر الصحي – ستُثار في المستقبل جنبا إلى جنب، مع مشاعر القلق العام التي تسود المجتمع، بشأن الوضع في سوق الإسكان، وهي المخاوف التي تزايدت منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا.
لكن ماذا عن المشكلة الأزلية المتعلقة بالسكن قرب جيران صاخبين؟ بالنسبة للصحفية كليا، لا يمثل ذلك قضية ذات بال. إذ تقول: “أحب أن أسمع جيراني وأصداء حياتهم الصاخبة. هذه هي الطريقة التي عشت بها على الدوام، وهذه هي الحياة بالنسبة لي. يروق لي ضجيج المدينة وصخبها. وبالنسبة لي؛ يمثل الإقامة في شقة جزءا من تجربة معايشة هذا الصخب”.
من جهة أخرى، فإذا كانت فترة الإغلاق تُميط اللثام عن الجوانب الأكثر سلبية المتعلقة بالإقامة في شقة سكنية؛ فإنها تُظهر كذلك أفضل ما في هذه التجربة. فالمقاطع المصورة، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، للإسبان وهم يصفقون ليلا لفرق الرعاية الطبية، أظهرتهم أيضا وهم يمارسون التدريبات الرياضية بشكل جماعي، ويلعبون بعض الألعاب معا، ويرددون أغاني عيد الميلاد لبعضهم بعضا من الشرفات.
من بين هؤلاء ميغيل كوبوس، الذي تحدثنا عنه في بداية هذه السطور، والذي يرى أن فترة الإغلاق أدت في الأساس إلى تعزيز روح التماسك الاجتماعي، أكثر من أي شيء آخر.
ويقول في هذا السياق: “أدى حبسنا بداخل منازلنا، إلى جعلنا أكثر إنسانية بقدر ما. فأنا مثلا أبقى لبعض الوقت في الشرفة بعدما ينتهي التصفيق، وذلك كي أثرثر مع جار أكبر سنا يعيش وحيدا بدوره، ثم نتبادل التحية، إلى أن نلتقي في اليوم التالي”.
المصدر: بي بي سي.