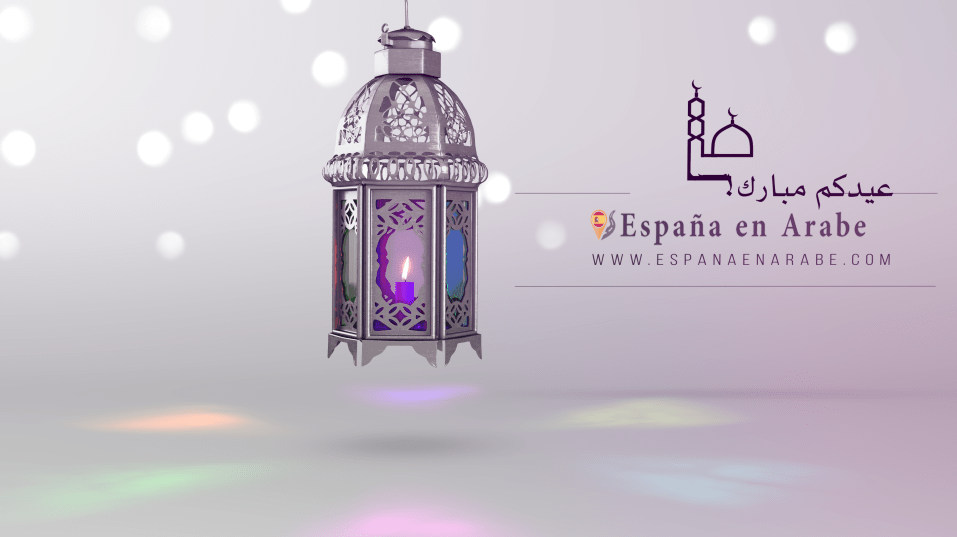العرب لم يستعمروا إسبانيا بل عمَروها الجزء 8: لغز انتشار الإسلام في آسيا وشمال إفريقيا وإسبانيا

أخبار إسبانيا بالعربي – تبقى في ذهن المؤرخ مسألةٌ عصيةٌ على الفهم و أكثر تعقيدا بكثير من إشكالية الغزو العربي المزعوم لإسبانيا, و تتمثل في مسألة انتشار الإسلام و الحضارة العربية. فإذا كان من المنطقي رفض التصور القائم على انتشار هذا الدين عن طريق قوة عسكرية أجنبية, لم يكن لها أي وجود حقيقي, فإنه ليس من الممكن نفي وجود حضارة عربية, لا قديما و لا حديثا. على أن الإشكالية في كلتي الحالتين تُطرحُ بشكلين مُختلفين, و بالتالي لا يُمكنُ حلُّهما بنفس الطريقة. فإذا كان من الممكن تفكيك خرافة الغزو العربي عن طريق النقد التاريخي بفضل توافر عناصر تُبينُ لنا كيفية تَكوُّن الأسطورة على مر القرون, فإن غياب التوثيق اللازم يجعل التاريخ المبني على تأريخ الحوادث عاجزا عن تفسير الميكانيزمة التي سمحت بانتشار الحضارة العربية. و نفس الامر يُطرحُ لفهم الحركات المشابهة التي ظهرت في الماضي, كتَشَكُّل الامبراطورية الرومانية و انتشار البوذية في آسيا.
كيف تخلت الجماهير التي كانت تعيش في بلاد الهند و تركستان و آسيا الصغرى و أقاليم بيزنطة القديمة و شمال إفريقيا و شبه الجزيرة الإيبيرية عن معتقداتها القديمة و اعتنقت هذه العقيدة الجديدة؟ ما هو هذا المبدأ الذي كان يُغيِِّرُ الثقافات المحلية القومية لتُوافقَ تصورات حياةٍ غريبة عن تراثهم الثقافي؟ كيف مثلا تحولت فجأةًَ مجتمعاتٌ أُحادية الزوجة إلى مجتمعات متعددة الزوجات؟
هذه الأسئلة المحيرة تُجيبُ عنها الرواية الرسمية للتاريخ دون مقدمات: من أعماق الصحراء العربية الكبرى ظهرت فيالق من المسلمين اجتاحت نصف العالم ساحقةً و ماحقةً كل ما جاء في طريقها. أما الناجون من الكارثة فقد رُبطوا بعربة المنتصرين. فذابت عناصر متباينة في بوتقة واحدة ما زالت عصية حتى اليوم. و بخصوص الجزيرة الإيبيرية, لم تطرح الرواية الرسمية أية إشكالية: فسكانها أُبيدوا بينما لجأت أقلية إلى الجبال الشمالية و عاشت أخرى مع السراسينيين (المسلمين) في ظلمات شبيهة بتلك التي عاشها المسيحيون الأوائل في سراديب الموتى. أهالي جبال أشتورياس الشمالية أسسوا مملكة نمت و اتسعت شيئا فشيئا بفضل عمل بطولي جبار. لقد استردوا, عمَّروا و نصَّروا الأراضي التي فقدها أجدادهم. يتعلق الأمر بهجوم مضاد استمر 7 قرون. بفضل هذه الملحمة انبعثت إسبانيا المعاصرة.
غير أن الدراسات التاريخية التي رأت النور منذ أواسط القرن التاسع عشر ما فتأت تشوه هذه الملحمة , و مع ذلك بقي ظل الأسطورة قائما لأن الباحثين لم يُفكروا في تصور مختلف للأحداث يُعوِضُ الأسطورة. عند مطالعة الإخباريات الأمازيغية و الوقوف على عدد الغزاة يُصاب القارئ بالدهشة. قبل سنوات وجه المؤرخ الإسباني أورتيغا إي كاسيت Ortega y Gasset ضربة أخرى للأسطورة السائدة حيث وضع أصبعه على الجرح المؤلم حينما علَّقَ: استردادٌ دام 7 قرون لم يكن استردادا. من جهتنا, حين نُصادفُ هذه الإشكالية في أبحاثنا حول تقهقر إسبانيا نستنتج أن الإشكالية أُسيءَ طرحها. كان من الأولى تحجيم الإشكالية العسكرية إلى درجة أحداث الحياة اليومية. كان من الأولى دراسة الإشكالية من زاوية ثقافية. حسب تطور الأفكار الذي سبق هذا الغزو المزعوم, تحولت شبه الجزيرة الإيبيرية إلى ميدان ملائم للصراع الأزلي بين الحضارات السامية و نظيراتها الهندوأوربية (38).
مع ذلك, بقي المشكل الحقيقي لغزا حقيقيا, و يتعلق الأمر بتلك الجماهير المسيحية التي اعتنقت الإسلام و تلبَّست الحضارة العربية. فلو افترضنا أن القوة هي التي أجبرت المسيحيين الإسبان على اعتناق الإسلام, فلماذا إذن عجزت نفس القوة عن دفع اليهود لاعتناق الدين الجديد رغم تعرضهم لنفس المعاملة؟ الأمر لا نقاش فيه. مع مرور القرون اختفت الساكنة المسيحية من البلاد المغاربية و من أغلب الأراضي التي وصلها الإسلام. أما الطائفة اليهودية, و التي تنتمي لنفس العرق السامي الذي ينتمي له العرب, فرغم تعرضها للاضطهاد و العبودية و إرهاقها بالضرائب, حافظت على تماسكها و تشبتت بهويتها إلى يومنا هذا. فهل كانت عقيدة المسيحيين أضعف من عقيدة اليهود؟ في حقيقة الأمر, لم يهتم المؤرخون كثيرا بهذه الإشكالية. فقد كانوا تحت تأثير الروتين فقبلوا الاحداث الخرافية دون أن يجهدوا أنفسهم في التثبت من صحتها أو على الأقل فهمها و إيجاد تفسير لها. المؤرخ الفرنسي جورج مارسي وجد الخرافة مريرة و أكبر من أن تبتلع فكتب “تطرحُ أسلمةُ بلاد الأمازيغ إشكالية تاريخية لا أمل لنا في حلها…لقد كانت هذه البلاد واحدة من البقاع التي عرفت انتشارا واسعا للمسيحية التي دخلت إلى قرطاج و المدن الساحلية ثم انتشرت إلى داخل البلاد. يقول ترتليانوس الإفريقي في نهاية القرن الثاني الميلادي:”نحن الغالبية تقريبا في كل مدينة”. كما كان للكنيسة الإفريقية آنذاك الكثير من الشهداء. كما فرضت نفسها بفضل فقهائها. إذا اضطُهِدت, افتخَرَت بانتماء القديس قبريانوس القرطاجي Cipriano لها. و إذا انتصَرَت, أسمعت صوت القديس أوغستين الجهوري لكل العالم المسيحي. بالإضافة إلى أن ديانة المسيح لم تكُن تُجند أتباعها من المدن فقط…فالعدد الهائل للمعابد البسيطة التي نجد أنقاضها في قرى الجزائر تبين حجم انتشار الإنجيل بين القرويين الأمازيغ. مع ذلك, و في أقل من قرن اعتنقت الغالبية العظمى من أبناء المسيحية هؤلاء الدين الإسلامي باعتقاد جازم قادر على الوصول إلى درجة الاستشهاد. و استمرت عملية الدخول في الدين الجديد في القرنين و الثلاثة قرون التالية حتى اختُتِمَ العمل بشكل نهائي و كامل. كيف يُمكنُ تفسير هذا التخلي عن المسيحية و اعتناق نقيضها المتمثل في الإسلام؟” (39).
نفس الإشكالية تُطرحُ بالنسبة لأمم شرقية كانت تحوز أقدم تراث مسيحي. كيف يمكن تفسير أن مصر, فلسطين, سوريا و أقاليم أخرى في آسيا الصغرى كانت تنتمي للامبراطورية البيزنطية تحولت بين عشية و ضحاها إلى دين محمد؟ لماذا تقبَّلت هذه الساكنة شريعة هذا النبي المنحدر من العمق البدوي؟ دراسات حديثة تبين أن الإسلام كان دوما اعتقادا حضريا. المؤرخ كزافيي دو بلانول Xavier De Planhol قدَّم أدلة مقنعة على ذلك: للبدوي عقلية متمردة. فهو يتصرف وفق حاجاته و أحيانا وفق نزواته. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون نموذجا للتدين. و الأمر في الماضي كما هو اليوم. لهذا تبلور الإسلام في المدن و ليس في الصحراء (40).
كانت الأقاليم البيزنطية القديمة تعيش حياة حضرية مهمة. كان كبيرا عدد المدن الغنية و الكثيفة السكان و التي تحتفظ بثقافة هيلينية مزذهرة جدا. يورد المؤرخ بريهيي: “و قد أُحصيَ أن عدد المدن التي تفوق ساكنتها 100 ألف نسمة لم يكن نادرا في آسيا الصغرى, سوريا و بلاد الرافدين و مصر عند الغزو العربي”. كان يقطن الإسكندرية 600 ألف نسمة. أما عدد سكان أنطاكيا في العصر الروماني فبلغ 500 ألف شخص. و بعد الأزمة التي عاشتها في عصر القديس يوحنا فم الذهب (347-407م) تراجع عددهم إلى 200 ألف قبل أن يرتفع إلى 300 ألف في القرن الرابع (41).
و يذكر بريهيي أيضا: “بالنظر للائحة الأساقفة المنسوبة لإبيفانيوس السلاميسي (توفي 403م) و المؤلفة حقيقة في بدايات القرن السابع الميلادي, من بين 424 أسقفية تابعة للقسطنطينية, 53 تنتمي لأوربا و 371 لآسيا” (42). هذا العدد يشيرُ بشكل أو بآخر لعدد المدن التي سيطرت عليها العقيدة المحمدية. حسبَ نفس الكاتب, كان بطريرك الإسكندرية, الذي بلغ من العظمة أن لُقِّبَ ب”البابا”, يُدير قبل الغزو العربي 10 مدن كبرى و 101 أسقفية. بطريرك أنطاكية الذي كان يُديرُ سوريا و الجزيرة العربية و صقلية و بلاد الرافدين كانت له سلطة على 138 أسقفية, كما تُشيرُ إلى ذلك معلومة منسوبة للبطريرك أنستاس (559-598م) (43). نفس الإشكالية تُطرحُ في البلاد المغاربية (44). فإذا كان الأمر غامضا في الغرب, فهو كذلك أيضا في المشرق. هكذا إذن, و على غرار تاريخ إسبانيا, يُخبروننا بأن هذه المناطق المزذهرة و المثقفة تعرضت فجأة لغزو العرب. و بما أنهم قدموا للتو من الصحراء, فقد كان من الضروري أن يجدوا أنفسهم أقلية في مواجهة الجماهير الحضرية للمدن الكبرى. فما من شك أن هؤلاء السكان المحليون الحضريون فُتنوا بسراب القفار البعيدة, فتمت صياغتهم و ملاءمتهم و تشكيلهم و فُركت أدمغتهم و عقولهم بفاعلية إلى درجة أنهم لم يصبحوا فقط محمديين غيورين و إنما أيضا دعاةً عدَّائين نشروا الخبر السعيد في ضفاف نهر كلاين في فرنسا و الإيبرو في إسبانيا و في الهند.
إن عملية رَومَنة, أسلمة, تغريب أو تشريق شعب ما – و ليعذرنا القارئ على استعمال هذه المفردات العجيبة- كانت ثمرة حركات واسعة و قوية للأفكار. و بالتالي الاعتقاد بأن أُمماً مزدهرة كانت تتمتع في عصرها بثقافة مهمة تخلت فجاة عن معتقداتها و غيرت طريقة تفكيرها بسبب غزوها من طرف حفنة من البدو القادمين حديثا من الصحراء هو تصور طفولي للحياة الاجتماعية. صحيحٌ أن البشر يتطورون, لكن يتطورون ببطء.
إن للبشرية رصيدا من الجمود يستدعي حدوث كوارث هائلة حتى تنهار الهيكلة الاجتماعية القائمة و تُفقدَ أو تُنسىَ العادات العزيزة الروحية منها و المادية. و بالتالي, فالأمر لا يُشبه تغييرَ الديكور كما يحدث في المسرح و خصوصا إذا كان المُكلَّفُ بالتغيير من البدو البعيدين عن الثقافة و الحضارة. الجميع يعلمُ التعصب للرأي الذي يكون عليه المُثَقَّف. و لإقناعه برأيك لا بُدَّ لك من الكثير من الهيبة. و من دون مفكرين و كُتاب لا مجال لتطور الأفكار: و بالتالي لا حضارات جديدة.
و إذا تركنا المركز نحو الهوامش يتعقد المشكل أكثر فأكثر. حتى عصرنا هذا, كان يسود الاعتقاد بأن انتشار الإسلام حالفه النجاح بسبب اعتماده في تحركه على هيبة حضارة عظيمة. و هذا اعتقاد يخالف الواقع. فالحضارة التي كانت مهيمنة آنذاك في الحوض المتوسطي كانت الحضارة البيزنطية. في القرن السابع الميلادي لم تكن قد ازدهرت بعد الحضارة العربية, حيث كانت في فترة المخاض, و لم تصل لذروة مجدها في المشرق إلا في القرن التاسع الميلادي, و في الغرب إلا في الحادي عشر ميلادي. و ما جرى كالعادة هو استباق المؤرخين للأحداث.
من جهة أخرى, جرى انتشار الإسلام في المناطق الهامشية بنسق أكثر بطئا, لأن المجال لم يكن متاحا لأكثر من ذلك. فكما أشرنا إلى ذلك في فصل سابق, تطلبت أسلمة بلاد البربر وقتا طويلا كما بيَّنَ ذلك جورج مارسي, و هو أمر لا يتماشى مع التصور التقليدي للتاريخ. فإذا كانت الحركة السياسية تطلبت 150 عاما من الصراعات المحمومة, فإن انتشار اللغة العربية تطلَّبَ قرونا طويلة. لا يُمكنُ أبداً النجاح في تغيير اللغات المحلية التي لازال يُتحدَّثُ بها حتى يومنا هذا. حتى اللغة اللاتينية صمدت في وجه الغازي: “هناك نصٌ للإدريسي يمَكِّنُنا من الجزم بأنه في عصره, أي في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي (أي بعد أكثر من 400 سنة على الغزو المزعوم) كانت تُستعمل بثبات اللغة اللاتينية في الجنوب التونسي. هذا العالم الجُغرافي يخبرنا بأن أغلبية الناس في قفصة كانوا يتحدثون اللغة اللاتينية الإفريقية” (45).
و إذا طرحنا الإشكالية الإسبانية وفق العرض التقليدي للتاريخ, فإن الهراء يتبدَّى واضحا و جليا. لقد تأسلمت إسبانيا و تعرَّبت على يد حفنة من الغزاة الذين لم يكونوا مسلمين و لا كانوا يتحدثون العربية. لكن لا مكان للهراء في هذه الحياة. يُطلقُ الهراء على الأمر غير المفهوم. و هذه الأحداث تبدو لنا غير معقولة لأن العلوم التاريخية كانت عاجزة عن تحليل الملابسات الحقيقية التي سمحت بما يبدو لنا تحولا هائلا. و للخروج من الورطة كان من الضروري النظر للمشكل من وجهة نظر عامة بما يوافق تطور الأحداث في جميع مناطق الحوض المتوسطي.
لفهم انتشار الحضارة العربية, لا بُدَّ من مقارنة حركات أفكارها مع حركات نظيراتها التي كانت موجودة في فترات أخرى في هذا المجال الجغرافي الشاسع. في ماذا كان يختلف انتشار مبادئها عن انتشار الحضارة الإغريقية أو الثقافة الرومانية؟
هذه المقارنة ستكون موضوع المقال القادم من سلسلة “العرب لم يستعمروا إسبانيا” على موقع إسبانيا بالعربي