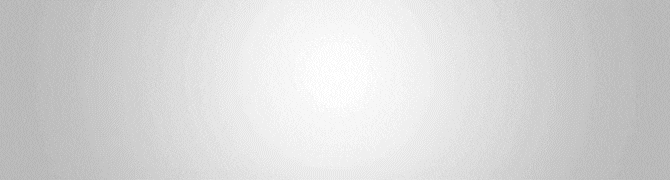مات وحيدًا في محطة قطار.. رحلة ليو تولستوي من المجون إلى الزهد والتنسك!

على فراش بارد ببيت صغير على محطة قطار، يرقد شيخ طاعن في السن، أصابه المرض والعجز، تجسيدٌ حي للنهاية. قضى ليو تولستوي عمره بأكمله باحثًا عن إجابة لتساؤلات لطالما أرقته، لماذا يحيا؟ وما الحياة؟ وفي تفتيشه عن حل لقضية الحياة كان أشبه بالرجل الضائع في غابة، يقبل على سهل فسيح، فيتسلق شجرة، وينظر من أعلاها إلى سهول واسعة لا تقف العين على آخرها، ولا مأوى يلجأ إليه فيها، يرى كل هذا فيدرك أن لا أحد فيها ينقذه، فيرجع إلى الأحراش، يتخبط في ظلمتها ولا يهتدي إلى ضالته المنشودة.
هكذا كانت رحلته الكبيرة في حقول المعرفة البشرية، تلك الرحلة التي زادته يأسًا، فلا وجد غايته في علوم الفلسفة، ولا شَفَت غليله الإجابات العلمية البحتة لعلوم الرياضيات والطبيعة، في النهاية لم يستطع أن يخادع فكرة أن كل شيء باطل، وأن الموت خير من الحياة. لم يورثه وصوله لهذه النتيجة شيئًا من الراحة، بل كان سرًا لتعاسته، تمامًا كما وصفتها كلمات قرأها لحكيم هندي: «إن الذي يوقن أن الآلام والأمراض والشيخوخة والموت شرور لا بد منها، يستحيل عليه أن يعيش برغد».
أما الآن، وهو يشعر بدنو الأجل، تبدو كل الإجابات والحقائق ضئيلة أمام حقيقة الموت. يشعر بطاقة من راحة مبهمة، ترتسم على شفتيه ابتسامة لا تكاد ترى، يغمض عينيه ويسبح في بحر عميق من الذكريات، يمر شريط حياته أمام عينيه، ودون إرادة منه تقريبًا، ينغمس في ذكرياته إلى زمن بعيد؛ زمن شهد مقدِم أحد أبرع الأدباء الذين حظيت بهم الإنسانية في تاريخها، الكونت ليف نيكولايفيتش تولستوي.

الطفولة.. بين يتم الأم ورفاهية الثراء
في ليلة شتاء باردة من شهر سبتمبر (أيلول) عام 1828، كان مجيئه إلى الحياة. تعود به الذكريات إلى ما يربو عن الثمانين عامًا، يفتش في أركان الذاكرة عن ملامح أمه بلا جدوى، كان رحيلها قبل أن يتم العامين أولى مآسي حياته. لفظت آخر أنفاسها بينما شقيقته الصغرى ماريا تشهق بأولى صرخاتها. كأن القدر يبادل حياة بحياة، ويكتب عليه شقاء يتم الأم، فلا يبقى من ذكراها في وجدانه سوى بعض صور زيتية باهتة الألوان لها، وأحاديث أبيه وإخوانه الأكبر عنها، الكونتس ماريا فولكوتسكي، صاحبة النسب الضارب في النبل، تمامًا كأبيه الكونت نيكولاي تولستوي، رجل الجيش التي تتنافى طباعه مع طباع العسكرية.
يذكر عن أبيه حس الفكاهة ورقة الطباع، وبغضه لصيد الذئاب والثعالب، مفضلًا عنه ركوب الخيل في الغابات، أو مرافقة أطفاله مع جرائهم، وجدّته لأمه، يشوب صورتها شيء من السحر، وهي تنحني لتجمع حبات البندق. لطالما قضى الليالي بحجرتها، يستمع إلى الحكايات الطويلة ذات الطابع الممتع على لسان قصّاصِهم الضرير.
حظي ليو تولستوي بطفولة سعيدة، بفضل الثراء الفاحش لعائلته. نال والده حكم مقاطعة «سانت فلاديمير»، إزاء خدماته بالجيش، وآل إليه ميراث مقاطعة «ياسينيا بوليانا» بعد وفاة زوجته، وأعانته في تدبير أمور المنزل الشاسع، وتربية أبنائه، إحدى قريباته، تاتيانا أليكانسدروفنا، أو العمة تاتيانا كما كان يحلو له ولإخوته مناداتها، فكانت الصورة الأقرب للأم في عقله ووجدانه.
كان منزلهم يغلب عليه طابع الصخب طيلة الوقت، لم يخل يومًا من الأقارب الزائرين أو الأصدقاء، ليستمتعوا جميعًا بممارسة كل ما يحلو لهم من ألون اللهو. أما هو فكانت متعته الأكبر قضاء الوقت مع والده، بينما هو منغمس في قراءاته، بمكتبته الضخمة، التي حَوَت ما يربو عن 20 ألف كتاب بـ30 لغة مختلفة، بينما ينفث دخان غليونه في تلذذ. كان يسعده أن يطلب منه تلاوة فقرات من كتب أليكساندرو بوشكين، لينغرس في داخله حب القراءة والاستطلاع والتفكر، الصفة التي لازمته حتى النهاية.
ثقافة: رواية الحنين إلى كاتالونيا: بين الحرب الإسبانية والحرب السورية
الصبا.. «الموت زائرًا» وبداية التساؤلات
على مدى سنوات عمره، لقنته الحياة دروسًا عدة، لم يكن ليو تولستوي قد تجاوز الثامنة من عمره عندما أدرك أن دوام الحال من المحال. انتقل مع عائلته إلى موسكو ليلتحق أشقاؤه الأكبر بمدارسها، ويرحل والده فجأة في صيف عام 1837، تاركًا فراغًا هائلًا في حياته، عانى معه صعوبة بالغة في تقبل حقيقة الموت، وبخاصة عندما لحقت جدته بابنها من فرط الأسى، لتبدأ تساؤلاته الفلسفية حوى الوجود والحياة في مرحلة الطفولة.
عاد مجددًا مع شقيقته ماريا إلى ياسينيا بوليانا، بينما انتقل شقيقاه للعيش مع عمتهم ألين، التي رحلت عن عالم الأحياء هي الأخرى عام 1841، ليحل الموت ضيفًا دائمًا على حياته، يأبى إلا أن يجرده من كل من أحبهم، لم يكن يملك في مجابهته شيئًا سوى ابتسامة تتسع مع سيل من الذكريات.
الشباب.. بين الجامعة والعربدة
كان في السادسة عشرة من عمره، فتى يتأرجح بين ريعان الصبا، وفتوة الشباب، عندما التحق بـ«جامعة كازان»، واختار دراسة الأدب الشرقي، بيد أن النجاح لم يحالفه بها. كانت أضواء المدينة أكثر إغراءً لشاب بثرائه، يحيا مع إخوته الذكور بعيدًا عن أي وصاية، انطلق ليعيش حياة السكر والعربدة، ويطارد بائعي الهوى. ومع فشله بدراسة الأدب، اتجه لدراسة القانون، ليقرر بعدها أن حياة الجامعة لا تناسبه، فغادر بعد ثلاث سنوات دون إفادة تذكر سوى معرفة ضئيلة ببعض لغات الشرق.
عاد أدراجه مجددًا إلى موطنه، وللمرة الأولى في حياته يتحمل مسؤولية إدارة أملاكه، ويواجه غمار الحياة وحده، ومعها بدأ صراعه الداخلي حول الغاية من حياته، هذا الصراع الذي رافقه حتى آخر حياته دون إجابة شافية، فلم يجد سوى أن يبث يأسه وإحباطاته أوراقه وأصدقاءه.
سرعان ما حاول الهرب من ذاته بانغماسه مجددًا في حياة الشبان النبلاء، منتقلًا بين موسكو وسان بطرسبرج، أدمن القمار وتراكمت عليه الديون لدرجة اضطر معها لبيع بعض ممتلكاته لسدادها، وصار ضيفًا دائمًا لحفلات شرب الخمور وملاحقة رفاق السوء، غير آبه لتحذيرات عمته، وفي أعماقه كان يدرك تمامًا حياده عن الطريق. توثق أوراقه مشاعره في إحدى اللحظات التي أفاق فيها من سُكره، إذ كتب يعترف: «أعيش حياة حيوانية، هجرت كافة مسؤولياتي وأعمالي تقريبًا، تعاني روحي من فرط التمزق».
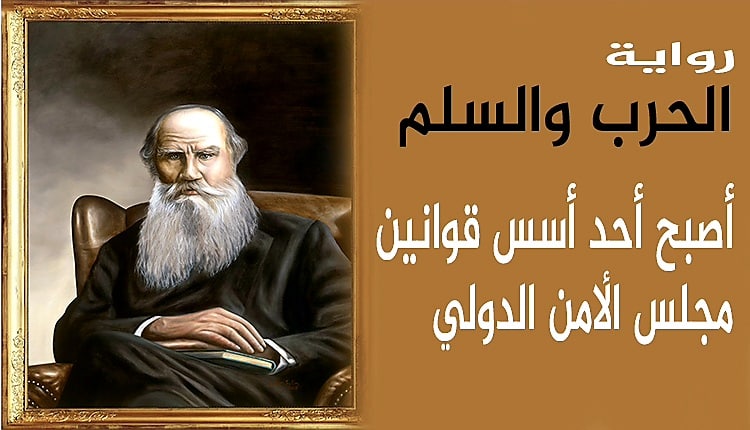
إلى أتون الحرب.. عندما أزكت الجبال والدماء نيران الأدب
كانت زيارة شقيقه نيكولاي، الضابط بالجيش الروسي، بمثابة طوق نجاة من صراعه الداخلي، رأى في بزته العسكرية أملًا ينتزعه من براثن التمزق، في رحلة بحثه عن غاية، كان الربيع قد حل عندما انضم للجيش. ارتحلا معًا عام 1851 إلى أقصى جنوب روسيا، حيث جبال القوقاز، تكاد تتراءى أمام عينيه صور الحياة البدائية التي شهدها بقرى جبال وسهول القوقاز، وبساطة قاطنيها، التي لم يجاوزها سوى استماتتهم في صده مع رفاقه أثناء حرب القرم، بشجاعة تركت فيه أثرًا لا يمحى.
عاد ليمارس عادته القديمة بكتابة مذكراته، إيذانًا بظهور ثلاثيته الأدبية، «الطفولة، والصبا، والشباب»، ولم تكن نظرته لها إلا مزجًا عابثًا بين الحقيقة والخيال. أربع سنوات قضاها في حياة العسكرية، كانت ذكرياتها مدادًا لأحداث روايته الأشهر: «الحرب والسلام». وصلته أخبار مرض شقيقه ديمتري، فعاد مجددًا ليراقبه يلفظ أنفاسه الأخيرة بالدرن. لم يطق بعدها البقاء، رحل إلى أوروبا الشرقية.
يبدو له من سخرية القدر أنه اضطر إلى إتمام مسودات كتابه الجديد لمجرد سداد مبلغ تورط به في لعب القمار. كان صراع الخير والشر بداخله قد بلغ ذروته، فجاءت كلماته تسجيلًا لواقع يرفل فيه بالآثام، ويتوق إلى مثالية متجسدة في صورة أمه.
«ألقيت بالعديدين إلى حتفهم بالحرب، خسرت بألعاب القمار، بددت أموالًا جنيتها بعرق الفلاحين بضيعتي، وأذقتهم صنوف العقاب، ضاجعت العاهرات، وخدعت العديد من الرجال، مارست الكذب والسرقة والزنا والسكر والعنف والقتل، لم أدع جريمة إلا وارتكبتها. مع ذلك، عدّني أقراني رجل أخلاق».
«كان طيف أمي يزور مخيلتي، كيان سام نقي، أقرب إلى الروحاني، في خضم صراعي مع مغريات الحياة في تلك المرحلة من عمري. أقمت الصلوات إلى روحها متوسلًا لها أن تساعدني، ولطالما ساعدتني هذه الصلوات».
ثم كان الحب وصراع جديد
يشعر وكأن صلاته قد أجيبت، وجد قلبه الحب تجاه شقيقة أحد أصدقائه، هجر حياة العبث وانغمس في كتاباته، ساعدته زوجته على ترتيب أوراقه وإدارة شؤون ضيعته، منحته الحب و13 من الأبناء، وخرجت إلى النور درة أعماله الأدبية، «الحرب والسلام» و«آنا كارنينا» صعدا به إلى شهرة ومجد لم يعبأ بهما في خضم صراعاته الداخلية، وراودته نزعة أخلاقية جديدة نتيجة شعوره الدائم بالتقصير في واجباته زوجًا وأبًا، لانشغاله بالبحث الدائم عن إجابات لأسئلته.
يدفعه ذلك الشعور لحالة من جلد الذات، أصيب معها بالاكتئاب وراودته الرغبة في الانتحار، فخط قلمه كتاب اعترافات ليكون بمثابة «الرحلة الأخيرة لتجلي الحقيقة التي منحته إياها كمال الحياة من كافة جوانبها، وسلام دافئ في رحاب الموت الآت».
اعترافات
تكاد تدفعه تساؤلاته إلى حافة الجنون، مؤلم ألا يكون لحياته غاية، ذلك الفراغ الذي التهم روحه حتى راودته فكرة الانتحار، لم يمنعه عنها سوى رغبة عارمة بتطهير أفكاره من آثام أوهامها، بيد أنه توقف عن ارتياد رحلات الصيد، خشية أن يوجه فوهة سلاحه إلى رأسه في لحظة ضعف تعتريه.
يخشى الحياة، يبذل قصارى جهده للخلاص منها، بينه وبين التخلي عن كل شيء خيط رفيع من التوق إلى شيء يجهله، وحنين في أعماقه إلى شيء لايدري كنهه، يقض مضجعه، التساؤل الأسمى في طريق البحث عن الذات، وماذا بعد؟ حاز كل أسباب السعادة، سلامة العقل والبدن، زوجة يبادلها حبًا بحب، وأبناء تقر لهم عينه، احترام القاصي والداني، وشهرة بلغت الآفاق.
مع ذلك، يتحايل ضد نفسه لئلا يضع لحياته حدًا، والمانع الوحيد له هو كراهية الموت، الذي يوقن أنه آت لا محالة، ليورثه عدمية تجعل من سعيه القديم نحو الكمال محض عبث، يدهشه أنه لم يستشف هذه الحقيقة منذ بداية حياته! كانت تلك الحيرة دافعًا له للتطهر من آثام العالم، هجر التدخين والمسكرات واللحوم، صار يدعو إلى الزهد في نزعة أقرب ما تكون لمظاهر التدين والصلاح والتي لطالما ناصبها العداء.
ألا أيها الموت أهلًا..
«أقاسي الآن عذابًا كالجحيم، يلاحقني خزي حياتي السابقة، تلك الذكريات التي لا تغادرني، تسمم كياني. يتخوف العامة أن يمحو الموت ذكرياتهم، ألا أي سعادة تلك، وأي ألم أن أذكر فيما بعد الموت شروري، وكل ما يوجع الضمير مما اقترفته في حياتي السابقة، يبهجني أن تختفي تلك الذكريات بالموت، ولا يبقى سوى الضمير».

ليو تولستوي في فراش الموت
تبدو الحياة له قطار سفر طويل لا يعرف وجهته، يريد أن تنتهي الرحلة وهو الذي كتب كثيرًا عن انعدام جدواها، كانت أفكاره وزهده في الحياة، ونزاعه الداخلي حول مغزى حياته بمثابة هُوة فصلت بينه وبين زوجته وأبنائه، ودون سابق إنذار رحل عن بيته، ترك خطابا لابنته أليكساندرا، يشرح فيه قراره، ويطالب بألا يلاحقوه.
تعود به الأفكار إلى واقِعِه الحالي، أصابه إعياء غامض على متن القطار، حملوه إلى منزل ناظر محطة «إستابوفو»، حيث يرقد ذلك الفراش البارد، انتابته نوبة من السعال، تراءى له شبح النهاية، أغلق عينيه واتسعت ابتسامته، وفي أعماقه، رحب بالموت، رفيقه القديم.
إسبانيا بالعربي.